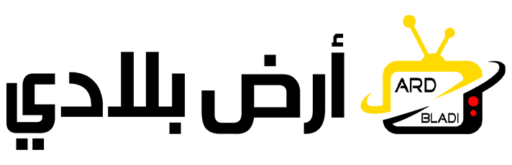جريدة أرض بلادي -ليلى التجري-
بقلم الأستاذة سعدية بلكارح-

الكتابة بالنسبة للكاتب الروائي مصطفى لغتيري حلقة وصلٍ بين حياته وفكره، إنها تختزل قولة ديكارت الشهيرة “أنا أفكر فأنا موجود” فقط يمكن للأستاذ لغتيري أن يقول” أنا أكتب إذن فأنا موجود”..لقد تجاوز هذا الكاتب الماطر عشرين مؤلفا، ولم يتجاوز بعد خمسين عاما من عمره.
الكتابة أحيانا تكون متنفَّسا يفتح آفاق التحليق للإمتاع والاستمتاع بين الكاتب والمتلقي..ولدى كاتبنا لغتيري تخالل أنفاسه في علاقة حميميةٍ تستثمر ماهيته كفكر يقارع التحدي في ابتزازٍ لوقته كاملا إلا ما تسرقه بعض الإرهاصات الحياتية ومتطلباتها الحتمية، لردحٍ قليل من الزمن ثم يعود لمعانقة معشوقته عناقا طويلا عميقا لا يفتر أبداً..هذه العلاقة المهووسة بينهما أنجبت للمكتبة العربية مقالاتٍ ورواياتٍ تختلف ثيماتها وتكنيكاتها باختلاف الرؤى والمؤثرات
التي راهنت تأثيثَها واختمارَها متشبعةً داخل فكره قبل مرحلة الوضع النهائي..
وهو الذي يقول عن الكتابة التي يسميها ورطة جميلة ما يلي:
“لا ريب أن كل ممارس للكتابة الإبداعية عموما والروائية خصوصا متيقن بأن سحر الكتابة يتجاوز جانبها التقني، المتمثل في رص الكلمات جنبا إلى جنب، وخلق شخصيات وأفضية تضطرب فيها هذه الشخصيات، يؤطرها زمن أو أزمنة متعددة، تختلف حسب رؤيا الكاتب وتصوره لذاته ولإبداعه وللعالم من حوله.
الكتابة أعمق من ذلك بكثير..إنها ورطة جميلة، تلقي بشباكها على الكاتب، وتأسره بخيوطها المخملية الرفيعة والمتينة، فلا يملك إزاءها حلا غير الاستسلام التام، فكلما حاول الفكاك منها، زادت تعلقا به في نوع من الزواج الكاتوليكي.. حينذاك تصبح الكتابة أسلوب حياة، يتنفسه الكاتب، و على إيقاعه المتعرج تمضي حياته، مأسورا يقدم لها نفسه و فكره وأعصابه قربانا يوميا .. أما الجائزة الكبرى التي ينالها فتتمثل في أنها قليلا ما تخونه، إنها وفية بقدر ما يمنحها من قلبه، مع أنها غيورة إلى حد التملك، أتذكر في هذا الصدد ذلك التعبير الجميل لطوماس وولف حينما شبه الكتابة بالدودة فيقول « لقد نفذت الدودة إلى قلبي و هي منطوية على نفسها تتغذى من مخي وعقلي و ذاكرتي» و أقول إنها دودة أسطورية لا تتوقف عن التضخم، حتى تحتل الجسد بأكمله، وهي لا تكف عن الازدراد بشهية مفتوحة، وعلى الكاتب أن يوفر لها غذاءها، والغذاء هنا هو تجربة الكاتب الحياتية و قراءاته، هذان المكونان هما الوقود الذي يحرك آلة الكتابة وبالطبع فالخيال يتوجهما.. الكتابة بدون تجربة عميقة في الحياة تغدو ضحلة سطحية و لا روح فيها .. أومن بأن الكاتب إن انطلق مما عاشه و يعيشه وخبره، بل ما رجه رجا عنيفا، ضمن لنفسه أسباب النجاح ..أما إذا اعتمد على الذاكرة فسرعان ما يجد طريقه نحو الإفلاس، وسيكرر ذاته في أحسن الأحوال أو يستنسخ كتابات الآخرين، في حين إذا اعتمد على تجاربه الخاصة، فإنه بالضرورة سيكون مختلفا ، لأن كل تجربة حياتية فريدة من نوعها ولا تتكرر أبدا إذ «لا نستحم في نفس النهر مرتين». طبعا لا يمكن استنساخ التجارب أو نقلها حرفيا بل يتعين أن تشكل الأرضية الصلبة التي ينطلق منها الكاتب، ثم يأتي دور الخيال الذي هو – بلا جدال – رأسمال الكاتب إن فقده، فقدت كتابته مبرر وجودها.
(انتهى كلام أ.مصطفى لغتيري)..
وأجزِم أن” الكتابة السليمة في القراءة السليمة “كالعقل السليم في الجسم السليم..وبهذا ينبني الترابط المتين بين المعادَلتينِ..لتأسيس
فكرٍ مُلِمٍّ بحيثيات الصنعة والغريزة المكتسَبَة حد الإدمان والافتتان..
عن التوأم الآخر للكتابة أو الشِّق الثاني، يقول أ.لغتيري:
تمثل القراءة الوجه الثاني لعملة الكتابة، إنها الزاد الذي تتغذى عليه الدودة المستقرة في مخ الكاتب.. القراءة متعة ووسيلة مثلى للتعلم و للتلاقح ولمحاورة إبداعات وأفكار المبدعين .. كل كتاب أقرؤه بمثابة رحلة اكتشاف جديدة و مائدة دسمة ، تفتح لي دروبا جديدة في عالم الكتابة ، و لا تكون القراءة مفيدة و ذات معنى إن لم أكتب عن الكتاب الذي قرأته ، و لا يتأتى ذلك إلا بعد قراءته مرات عدة ، القراءة الأولى استكشافية و الثانية تأملية و الثالثة حوارية و الرابعة للقبض على ما سكت عن ذكره الكاتب و هكذا دواليك .. كل قراءة جديدة لكتاب ما تكسبني خبرة جديدة.
الكتابة حياة مضاعفة. كيف ذلك؟ إنها تفتح للكاتب المجال للعيش حياة أخرى بل حيوات مفترضة، أجدني أقول « ما أضيق العيش لولا فسحة الخيال» ..بالخيال يحيى الكاتب، يبني عوالم ثم يهدمها ليبني غيرها، يحرك شخوصه في فضاءات من ابتكاره، يضع شيئا منه في كل شخصية من شخوصه ، وكأنه يوزع دمه ما بين القبائل، إنها لعبته الأثيرة
ما كتبته لحد الآن من روايات يتيح لي أن أقول مطمئنا بأن وراء جلها تجارب حيايتية قوية ، عشتها في حينها بكل جوارحي، وبعد مرور قدر من الزمن كاف لاختمار التجربة، استثمرتها في الكتابة، فقط أتمنى أن أكون وفقت في ذلك.
انتهى كلام أ.مصطفى لغتيري..
ونحن نقرأ رواياته على الخصوص غير المقالات العديدة والمؤلفات الأدبية والتربوية المتنوعة المناهج، نكتشف سر هذا الإشعاع الذي يطبع كتابات الأستاذ لغتيري، إضافةً إلى ثقافته الشاسعة المكتسَبَة من القراءة المتنوعة كما جاء في مقاله..
وتشبعه بتجاربه الحياتية المختلفة وبالتقاطاته المرَكَّزة لكل ما يغني تجاربه تلك.. فإن القاسَم المشترَك في تلك المؤلفات كلها هو صدق إحساسه بما يكتب مما يخَوّل له تجاوبا عميقا مع قرائه..و إفراغ النصوص من ذاته أو إعدام الذات كما يقول برانت..
نعرج على بعض الروايات الجميلة لنطلع على ثيماتها المحورية لنجد في رواية رجال و كلاب ، اعتمدت تداعية الخطاب كعلاج ناجع للتخفيف من حدة مرض الوسواس القهري الذي أصيب به البطل “علال” كحلٍّ لتجاوز محنته المرضية..وهذا الاضطراب هو كناية ربما أو همزٌ مقصود من الكاتب لضرورة الحوار لتجاوز كل المعضلات.. وهذا تحفيز للتحليل النفسي الذي يجعل من جلساته مع المريض استراحة للاسترخاء تحت ظلال الحروف..
في رواية «عائشة القديسة» أو “الجنية” فهي تعكس موروثا ثقافيا في الذاكرة الشعبية لدى المواطن العادي الذي يؤمن ببعض الخرافة أو الأسطورة من خلال كشف حقائق كانت مغَيَّبة عليه..
يستمتع فيها القارئ ببعض التفاصيل الجميلة والمثيرة..
أما رواية «أحلام النوارس» فيقول مؤلفها أ. مصطفى لغتيري:
فكنت محكوما فيها بإرجاع بعض الدين لفئة من الناس دفعت ضريبة كبرى من شبابها وصحتها وحياتها أحيانا، من أجل أن أنعم بهذه الحرية النسبية التي تتيح لي الكتابة دون رقيب خارجي، أقصد شبابا ناضلوا وأمسكوا بالجمر ملتهبا فدفعوا الثمن سجنا وتعذيبا وعاهات، من أجل أن تتحقق لغيرهم حياة أفضل، كتبت هذه الرواية على شكل رسالة مطولة بعث بها مناضل وسجين رأي سابق إلى حبيبته، التي تخلت عنه كما تخلى عنه الجميع، فانزوى في غرفة قصية منعزلة هي امتداد لزنزانته ، التي حملها معه في دواخله ،ليكتب رسالته الأخيرة..
وعن رواية «ليلة إفريقية» يقول:
كنت محكوما بتكنيك الكتابة ، فوظفت تقنية رواية داخل رواية، أو ما يصطلح عليه ب بتقنية «دمى البابوشكا الروسية»، كما استثمرت تقنية الميتا رواية، بما يعني أن الرواية تفكر في ذاتها بصوت مسموع، وهي تنكتب أمام أعين القارئ، كما شغلني من حيث الثيمات التعدد الثقافي للمغرب ، ممثلا في البعد الإفريقي الذي يبدو مغيبا بسبق إصرار و ترصد، دون أن تعزب عن الذهن هموم الكتاب وحياتهم السرية وعلاقاتهم، خاصة فيما يخص صراع الأجيال..(انتهى كلام الكاتب)..
وفي رواية «رقصة العنكبوت» نلاحظ تصويرا لصراع طبقي هائل تفصل بينها هيمنة طبقة برجوازية سائدة على فئاتٍ مستضعَفة لا تُبقي ولا تَذَر لها من الحقوق شيئا.. مما يفضي بالبطل إلى الوقوع فريسة في يد أحد الشواذ جنسيا من تلك الطبقة المستعْبِدة، ممثلة في تاجر لوحات ، يستغلُّ الفن لغرض في نفسه وتحقيق نزواته الشاذة ، أما على مستوى التكنيك فتدخل في إطار القصة القصيرة..
أما في رواية ابن السماء ففلسفتها دحض الخرافة التي لازالت تهيمن على بعض العقليات المغربية والعربية كما في أساطير الأولين.. وذلك من خلال شخصية “غريبة” نفذت من السماء حيث السمو إلى الأرض حيث الشر والقبح لتقوم بإصلاحه فإذا بها تفقد مسارها الحقيقي إذ استُغِلَّتْ شر استغلال من أجل مكاسب دنيوية واهية..
أما في رواية «على ضفاف البحيرة» فإن السحر الجمالي للإنسان الأطلسي والطبيعة الخلابة شكَّلا محورين أساسييْن اشتغلا عليهما الكاتب في روايته..حيث اعتمد تصويراته البليغة..
أما في رواية «أسلاك شائكة « فإن البعد التاريخي والجغرافي للمغرب مع الجارة الجزائر قد كشف كثيرا من الدسائس السياسية المضمَرَةِ لإفراغ منطقةٍ غالية من ترابنا من محتواها الثقافي التاريخي..
(يقول الروائي لغتيري: اقتبست أحداث الرواية لتكون فيلما قد يرى النور قريبا، مشكل الحدود المغلقة ما بين المغرب والجزائر وتأثيراته الكارثية على الإنسان في البلدين…)
أما عن روايته الأخيرة عروس الموسم الأدبي والتي توجت بدعاية كبيرة من الصحف الوطنية ومتابعة جميلة من المهتمين..
والتي عنونها الكاتب بــ” الأطلسي التائه” فإانها بمثابة قفزة تختلف عن سابقاتها ونقطة تحول كبيرة جدا في المسار الأدبي للكاتب لغتيري تضْفي طفرة نوعية للمكتبة المغربية والعربية..
تكسِّرُ اعتقاداتٍ أخرى في الموروث الثقافي الذي يقدس بعض الأضرحة ل”الأولياء الصالحين” دون الضلوع في نمط حياتهم بشقيْها “الإنساني العادي” و”المكتَسَب التحَوُّلي”..
الرواية قالت عنها دار الأدب ببيروت: عن دار الآداب ببيروت صدر حديثا للروائي المغربي مصطفى لغتيري رواية جديدة، اختار أن يعنونها بـ ” الأطلسي التائه”، حاول من خلالها صياغة حياة شخصية أحد أهم أقطاب التصوف في المغرب، ويتعلق الأمر بأبي يعزى الهسكوري، الذي تطلق عليه العامة”مولاي بوعزة””، وتعد هذه الرواية الثانية عشرة في مسار الكاتب، ومما جاء في تقرير لجنة القراءة عن هذه الرواية:
ينمو السرد في هذه الرواية من منظور نقدي هادئ لعدة أمور عانى منها المغرب العربي في مرحلة من تاريخه هي مرحلة انتفاضة الموحدين ضد المرابطين، ولكن دون أن تكون هذه الرواية رواية تاريخية، بل هي حكاية الراوي لسيرته أو لما عاشه وشكَّل سيرة له وللواقع الثري الذي تقلَّب فيه وعاينه.
بداية نتعرف إلى الراوي وهو يافع يعاني من طوله غير الطبيعي ونزوعه الأنثوي إلى أمه وجدته، ومن قمع والده له وتسلطه الذكوري عليه وعلى أمه، وعندما يرسله والده ليعمل راعيًا عند الشريف الشرقاوي نتعرف إلى ما يكمن في عمق شخصية الراوي من نزوع صوفي يتمثل في علاقته بالطبيعة وبأعشابها التي يتحرّى فوائدها مقدمًا لنا معرفة ثرية ومدهشة.
في عمله كراعي غنم يتعرّف بإبراهيم، الراعي الآخر عند الشريف، وفي الحوار بينهما نتعرّف إلى الواقع السياسي ومجرياته: موت الأمير يوسف بن تاشفين، ابنه علي الذي يخلفه بعد أن يقضي على تمرِّدٍ قاده ابنُ عمه في فاس… كما نتعرّف إلى النشاط الثوري الذي يقوده علي ابن الشريف الشرقاري ومعه، سرا، إبراهيم المناضل الثوري.
تزخر هذه الرواية بالمعلومات المروية من خلال تنقل الراوي بين مدن وبراري المغرب ومن خلال المتعبّدين والنسّاك الذين يلتقي بهم ويزودونه بطريق المعرفة الذي وكما يقول لا حدود له “وأن الله وحده قادر بأن يلقي بنوره على من يشاء من عباده”..
ومقابل انصرافه إلى هذه المعرفة، وعلى أساسها، يحكي عن الناس وما يضفيه خيالهم من قصص على ما يجري في الواقع من حقائق.. وهو بذلك يكشف عن وعي جمعي سحري يجعل الناس يروون ما يتهيأ لهم ويصدقونه ويمارس، في الآن نفسه، نقدًا غير مباشر للمعتقدات الشعبية التي تتحول عندهم إلى حقائق هي بديل المعرفة وصورة للجهل والتخلف الفكري.
باختصار هذه رواية ثرية مروية بأسلوب سلس كلاسيكي متعته فيما ترويه من أحداث تقع، وبشكل رئيسي، للراوي “أبو يعزى الهسكوري”. إنه أسلوب الحكايه التراثية القائم سردها على المقدمة والحبكة المميزة بتوالي العقد ثم النهاية/الحل التي لها وقعها عادة في نفس القارئ.
يسرّنا نشرها بدافع الإضاءة الثقافية التي تقدمها للقارئ إضافة للمتعة السردية التي تحققها له.