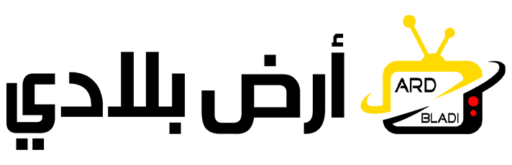جريدة أرض بلادي-ليلى التجري-
بقلم الكاتب المغربي مصطفى لغتيري-

لا أحد تقريبا يجهل بأن كلا من الأدب والسينما ينتميان إلى الفنون الجميلة، وهذا يعني أن هناك ما يوحدهما، فانتماؤهما معا إلى هذا الفرع الكبير من الثقافة الإنسانية لا يمكن أن يأتي عفو الخاطر، بل لابد أن يكون هناك ما يبرره. وإذا ما دققنا النظر في هذا الانتماء وتأملنا في نفس الوقت هذين الفنين كليهما، ستستأثر باهتمامنا-بدون شك- كلمة فن التي تجمع بينهما، والتي يمكن تعريفها بكونها التعبير عن عمق الكينونة الإنسانية بأشكال إبداعية متنوعة، تتجاوز متطلبات عيش الإنسان اليومية، لتنغمس في تأمل ماهيته النفسية والوجودية والروحية. ولعمري فالإنسان نتيجة لاهتمامه بهذا الفن يحقق إنسانيته من خلال الرقي والتعالي عن حيوانيته ورغباته الغريزية الملحة.
ينقلنا هذا التعريف مباشرة إلى الأدب والسينما، وسوف نضرب صفحا عن الاختلافات الكثيرة والظاهرة فيما بينهما، والتي يضيق المجال لحصرها في هذا المقال، ويكفينا -بالمقابل- التوقف عند ما يجمع بينهما وهو بالأساس الطابع الإبداعي، الذي يميز كل منهما، فالأدب فن إبداعي أداته الكلمة، والسينما فن إبداعي كذلك، لكن أداتها الصورة، كما أنهما يشتركان معا في خاصية الخيال، التي تجعل كل منها قابلا للوجود، فلولا الخيال لما كان هناك أدب أو سينما، فكل من ممارسي هذين الفنين يتميزون بقدرتهم الفائقة على الخلق، إذ أنهما ما ينفكون يبهروننا بحيوات جديدة يبرعون في اجتراحها، تجعل الاهتمام بهما له ما يبرره.
كما أن كلا من الأدب والسينما -وأتحدث هنا عن الرواية والقصة كجنسين أدبيين- يتميزان بطابعهما السردي، والذي لا يعني سوى تطوير أحداث تقوم بها شخصيات، تنطلق من نقطة معينة وتنتهي في نقطة أخرى، دون أن يعني ذلك تطورا كرونولوجيا خاضعا للزمن الطبيعي، الذي يبتدئ من ساعة معينة لينتهي في ساعة أخرى، وتكون الأولى متقدمة عن الثانية زمنيا، بل يمكن لكليهما توظيف الزمن النفسي كذلك، الذي تتداخل فيه الأزمنة بشكل قد يصيب بالإرباك أحيانا، كما يمكنها الانطلاق من النهاية ليصلان فيما بعد إلى البداية المنطقية للأحداث.
ولعل هذه الخاصية المشتركة الأخيرة هي التي حفزت السينما وروادها لاقتباس كثير من النصوص الروائية من أجل تحويلها إلى أفلام، حققت –بدون شك- نجاحات مبهرة وسارت بذكرها الركبان، فأنتجت لنا ما يسمى بسينما المؤلف، وقد لمعت في هذا الخصوص أفلام بعينها، حافظت على أسماء الرواية المقتبسة الناجحة، فأضحت أيقونات تؤشر على هذا التعاون القوي ما بين الأدب والسينما، فمن منا سينسى فيلم « ذهب مع الريح » المقتبس عن رواية للكاتبة الأمريكية مارغريت متشيل بنفس الاسم ومن إنتاج دايفيد سيلزينغ وإخراج فيكتور فليمنغ. وفيلم « العجوز والبحر » المقتبس عن الرواية الشهيرة للإيرنيست هيمنغواي، وفيلم « مدام بوفاري » المقتبس عن رواية بنفس الاسم لغوستون فلوبير، والنماذج العالمية كثيرة يصعب حصرها هنا، وهي تؤشر في أحد مستويات التأويل عن عمق العلاقة ما بين الأدب والسينما.
وقد أدلت السيينما العربية بدلوها في هذا التوجه الثري والباذخ، إذ عمد المخرجون والمنتجون في مجال السينما العربية إلى الاستفادة من النبع الثر للرواية العربية، فاقتبسوا منها نصوصا لامعة، وحولوها إلى أفلام سينمائية، أضفت على الشاشة الكبرى جاذبية خاصة، وقد تحقق زخم مشهود في هذا المجال خلال المرحلة الرومانسية، التي غزت الرواية العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين وبعده بقليل، ممثلا بروايات إحسان عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله، وقد كان أوج تعاطي السينما العربية مع النصوص الروائية مع التجربة الروائية للفائز العربي الوحيد بجائزة نوبل للآدب عام 1988 وأقصد الكبير نجيب محفوظ، الذي لم يكتف بمنح السينما دررا من إبداعاته الروائية لتحويلها إلى أفلام، بل كتب هو نفسه عددا من السيناريوهات للسينما. وكمثال على ذلك يمكن أن نشير فقط إلى فيلم « اللص والكلاب » الذي تم إنتاجه عام 1962 والأثر الذي خلقه في تلك الفترة وما بعدها، لنبرز الأهمية التي اكتساها هذا التعاون الفعال والمنتج ما بين السينما والأدب.
أما بخصوص التجربة المغربية في هذا المجال فتبدو محدودة إلى حد كبير، فالأفلام السينمائية التي اقتبست روايات كتبها مغاربة تبدو محدودة جدا ومخجلة، وقد حظيت نصوص قليلة جدا بهذا الشرف، وهي حسب علمي « جارات أبي موسى »لأحمد التوفيق و »بولنوار » عثمان أشقرا وقصة بامو لأحمد الزيادي والغرفة السوداء لجواد امديدش، وربما غيرها قليل جدا، كما أن روايتي » أسلاك شائكة » الصادرة عندارالوطن في المغرب عام 2012 وعن دار النايا بسوريا عام 2013، والتي تناولت فيها معضلة إغلاق الحدود ما بين المغرب والجزائر، تم اقتباسها لإنجاز فيلم » الوشاح الأحمر »، غير أن مخرجها مازال يتماطل في الاعتراف بذلك، رغم توفري على عقد موقع من طرفها، يفيد بذلك.
وإذا ما حاولنا الوقوف عند مشكل محدودية اقتباس السينما المغربية لروايات الكتاب المغاربة لتحويلها إلى أفلام، وحددنا أهم أسبابه، وجدناها فيما يلي:
التكوين الفرنكوفوني لأغلب المخرجين المغاربة مما يجعل اطلاعهم على الروايات المغربية المكتوبة باللغة العربية محدودا جدا.
ظاهرة المخرج المنتج الممثل الكاتب، فللأسف هناك مخرجون يفضلون القيام بكل شيء، وفي المحصلة النهائية لا يقومون بأي شيء.
تأثر الرواية المغربية في إحدى مراحلها بالرواية الفرنسية الجديدة، أو الكتابة عبر نوعية، ومن نتيجة ذلك الاهتمام المفرط باللغة الشعرية وإهمال البعد الحكائي، الذي يهم السينمائيين أكثر من غيره.
عدم التعريف بالروايات الجديدة التي بدأت مع تسعينيات القرن الماضي تتصالح مع البعد الحكائي، وتنتج بالتالي نصوصا قابلة للاقتباس سينمائيا.
التوجس وسوء الفهم الذي يحكم العلاقة ما بين المخرجين والأدباء، بسبب الأحكام المسبقة وتأثير بعض التجارب السيئة، التي يشتكي فيها الأدباء من السطو على حقوقهم المادية والمعنوية، فيما يشتكي المخرجون من عدم مرونة الأدباء حين يضطرون إلى إجراء تغييرات على النصوص الروائية حتى تصبح قابلة للاشتغال عليها سينمائيا.
ودون التوغل في هذا الجرد لمعيقات التعامل ما بين الأدباء والسينمائيين، نكتفي بالإمساك بخيط التفاؤل، لنقول بأن العلاقة ما بين الأدب والسينما محكومة آجلا أو عاجلا بربط الوشائج القوية فيما بينها، خدمة للثقافة المغربية أدبا وسينما، حتى نمضي قدما في خطوة الألف ميل من أجل خلق نصوص أدبية وسينمائية تقدم وجها مشرفا للإبداع المغربي، نكسب بفضله موطئ قدم في المشهد الإبداعي العربي والعالمي، وما ذلك على مبدعينا بعزيز.