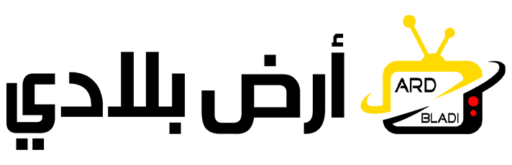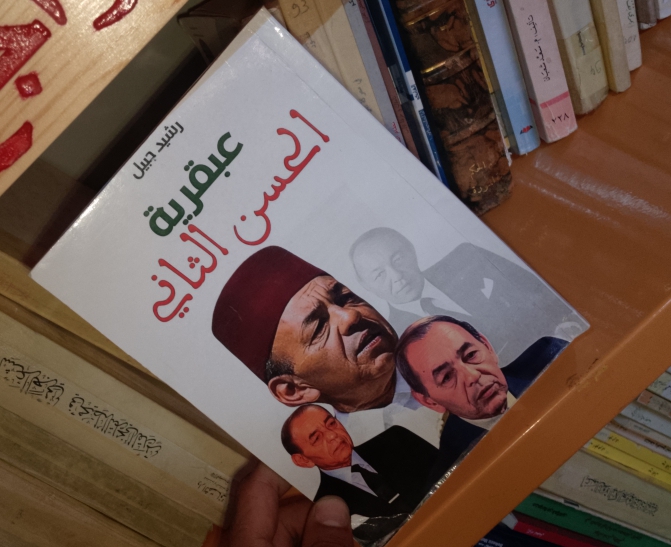جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
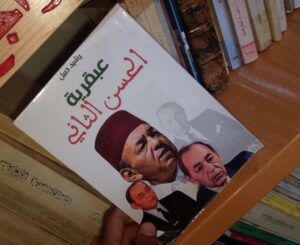
قال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي: “القيادة ليست امتلاك القوة، بل القدرة على صناعة اتجاه العالم حين يتوقف الجميع عن الرؤية.”
وفي لحظة استحضار لملامح القادة الذين صنعوا لأنفسهم مكاناً في ذاكرة الأمم، تتقدّم صورة المغفور له الحسن الثاني بوصفه واحداً من أولئك الذين لم ينتظروا أن تُمنح لهم الأدوار، بل اختاروا أن يصنعوا المسرح، ونصّ المسرح، وقواعد اللعبة. لم يكن ملكاً يراقب مجرى التاريخ، بل كان مهندساً يعيد رسم مساراته، بحدسٍ نافذ وفكرٍ مُنقّى من العشوائية، كأن الزمن بالنسبة إليه مشروع هندسي يحتاج إلى ضبطٍ في المقاييس ودقّة في الحسابات وإحاطة شمولية بالمعادلات.
في قراءة متأملة لمسار الراحل الحسن الثاني، يجد الباحث نفسه أمام شخصية تشكّلت من عناصر متعددة: عقل سياسي صلب، نفس استراتيجي طويل، ثقافة موسوعية تزاوج بين الفقه والقانون والفلسفة والتاريخ، وحضور قوي قادر على تحويل الوقائع البسيطة إلى إشارات دبلوماسية، وبناء القرارات على خيوط دقيقة تجمع بين الحزم والرؤية والتوازن. لم تكن عبقريته مصادفة، ولا وليدة ظرف طارئ، بل كانت تراكم معرفة، وصقل تجربة، وتربية فكرية أثمرت ملكاً يقرأ العالم كما يقرأ الرياضيون معادلات الجبر العليا.
إن ما يمنح شخصية الحسن الثاني خصوصيتها ليس فقط قدرته على الحكم، بل قدرته على تحويل الحكم إلى منظومة عقلانية متماسكة، قائمة على التخطيط البعيد وترتيب الأولويات وفهم قوانين الصراع الدولي. لم يكن مسكوناً بهاجس الردود اللحظية، بل كان معنياً ببناء الهياكل العميقة التي تصمد بعده. هنا تتجلى إحدى أندر الصفات في القيادة: القدرة على التفكير خارج الذات، واعتبار الدولة كياناً زمنياً يمتد أبعد من الجسد واللحظة والمرحلة.
وعند التأمل في معمار رؤيته، يظهر بوضوح أنه لم يكن يقود عبر القرارات المجتزأة، بل عبر فلسفة دولة، تُبنى فيها السلطة على المعرفة، ويُبنى فيها القرار على تراكم الأدلة، ويُبنى فيها المستقبل على قراءة دقيقة للممكن وللمحتمل وللمخفي بين ثنايا التحولات. لقد امتلك، كما تصفه المراجع، ذكاء استراتيجياً يجمع بين الواقعية الصارمة والمرونة الحاسمة، وبين الثبات في المبادئ والقدرة على التكيّف مع لحظات الانعطاف.
كان الحسن الثاني قارئاً للطبيعة البشرية بمهارة، يعرف كيف تُدار النفوس، وكيف تُضبط توازنات القوى، وكيف تُبنى التحالفات في عالم لا مكان فيه للضعفاء. كان يدرك أن القوة ليست في امتلاك السلاح، بل في امتلاك المشروعية، وأن الشرعية ليست في الخطاب وحده، بل في القدرة على الحفاظ على تماسك الدولة، واستمرارية المؤسسات، وإبقاء الوطن فوق العواصف مهما بلغت شدتها. لذلك ظل المغرب في عهده صامداً، لا ينهار حين تتهاوى المنطقة، ولا يتفكك حين تنزلق الجغرافيا المحيطة إلى الفوضى.
ولعل من أبرز ملامح عبقريته تلك القدرة الفريدة على تحويل الأزمات إلى فرص. ففي مراحل الشدة، كان يظهر بأكثر قدر من الهدوء، كما لو أن الإعصار نفسه يخشى الاقتراب من ذلك الهدوء الممشوق بالحكمة. كان يواجه الصعاب بمنطقٍ لا يهاب اتخاذ القرارات الصعبة، وبوعيٍ لا ينخدع بالتقلبات العابرة. إنه ذلك النوع من القادة الذي يُحسن قراءة “ما تحت السطح”، فيعرف متى يفاوض، ومتى يضغط، ومتى يصمت، ومتى ينطق بكلمة تُغيّر اتجاه الحدث كله.
ومن بين الروافد الكبرى لعبقريته، تلك القدرة الاستثنائية على بناء رمزية الملكية كمرتكز للهوية المغربية. لم يتعامل مع العرش بوصفه سلطة، بل بوصفه ذاكرة جماعية، وإرثاً سياسياً، ومؤسسة تستمد قوتها من التاريخ، لا من الظرف. لذلك استطاع الحفاظ على تلك الصلة الدقيقة بين الدولة والمجتمع، بين السياسي والثقافي، بين الحاضر العاجل والهوية الضاربة في عمق القرون. لقد أدرك أن المغرب ليس رقعة جغرافية، بل كيان روحي، وأن الأمة التي تُدرك نفسها تستطيع أن تصنع طريقها مهما تعاظمت التحديات.
ولم تكن حداثة الحسن الثاني مجرد انفتاحٍ على تجارب الآخرين، بل كانت مشروعاً أصيلاً يتأسس على مبدأ التراكم المتدرج. فقد فهم أن التغيير لا يُفرض بالعنف والقطائع، بل يُبنى عبر جسور بين القديم والجديد. من هنا جاءت رؤيته الإصلاحية، التي جمعت بين بناء المؤسسات، وتطوير البنى التحتية، وتحويل الدولة إلى كيان عقلاني يفكّر بمنطق التخطيط لا بمنطق التفاعل اللحظي.
وحين نتأمل أفق سياسته الدبلوماسية، تتجلى صورة رجل يمتلك هندسة كاملة للخرائط، يدرك أن مكانة الوطن لا تتأسس بالصوت المرتفع، بل بالثبات الاستراتيجي والحنكة في إدارة العلاقات، وقراءة التحولات الدولية بعين منفتحة. لقد كان يجالس القادة الكبار، محاوراً ومحاججاً، لا تابعاً ولا متردداً، ويضع المغرب في موقع الوسيط، والموازن، والفاعل الذي تُحسب له الحسابات. هذه القدرة على إنشاء “هندسة التوازن” أكسبت المغرب احترام محيطه، وفتحت له منافذ لم تكن دول أكبر قادرة على الولوج إليها.
وفي العمق النفسي والفكري، كان الحسن الثاني نموذجاً للقائد الذي يفكر بمنطق “الوحدة الفكرية”. لم يكن يترك الفكرة تتشتت، بل كان يجمعها في خيط واحد، ثم ينسج منها رؤية. امتلك لغة دقيقة، مصقولة، ذات طابع فلسفي، تُظهر قدرة على تحويل الأفكار المجردة إلى معادلات سياسية. أحاديثه، خطبه، وتفسيراته للأحداث تظهر رجلاً يتحدث كقاضٍ، ويفكر كمؤرخ، ويحاور كدبلوماسي، ويرسم السياسات كاستراتيجي محترف. هنا تتجلى عبقرية الكلمة التي تُقنع، لا لأنها مُنمّقة، بل لأنها مبنية على منطق صارم، وترابط متين، واستحضار لمرجعيات واسعة.
وفي البعد الإنساني، كان الرجل يحمل حساً خاصاً، لا يظهر بسهولة، لكنه حاضر بقوة في اختياراته الكبرى. كان ينظر إلى شعبه كما ينظر ربّان السفينة إلى ركابها وقت الطوفان: مسؤولية عالية، وحرص لا يلين، ورغبة دائمة في أن يصل الجميع إلى الشاطئ دون أن تُكسر المركب. لذلك نجده يربط الحكمة بالفعل، والرؤية بالإرادة، والمستقبل بإعداد بنيات تُناسب تحدياته.
إن عبقرية الحسن الثاني ليست حدثاً عابراً، ولا وصفاً إنشائياً، بل هي حقيقة تاريخية تشهد عليها آثار حكمه، وندرة ملامحه الفكرية، وإحاطة رؤيته بالممكن والمستحيل معاً. لقد كان رجلاً يعيش بعقل أكبر من زمنه، وقلب أكبر من جغرافيته، وإصرار يُحوّل الفكرة إلى دولة، والدولة إلى مسار، والمسار إلى تاريخ. إن قراءة سيرته ليست مجرد عودة إلى الماضي، بل هي محاولة لفهم كيف استطاع قائد أن يرسم معالم المغرب الحديث، وأن يترك بصمة لا تزال تؤثر في حاضر البلاد ومسارها.
وهكذا، حين نضع ملامح شخصيته تحت ضوء التحليل، نجد أنفسنا أمام رجل لم يكن يُجيد إدارة اللحظة فقط، بل كان يتقن فنّ صناعة الزمن، ويحوّل من المغرب دولةً ذات عمق، ورؤية، وامتداد، واستمرارية. قائد لا يشبه إلا نفسه، ولا ينتمي إلا إلى طينة أولئك الذين وصفهم كينيدي: أولئك الذين يصنعون الاتجاه حين يعجز الآخرون عن رؤية الطريق.