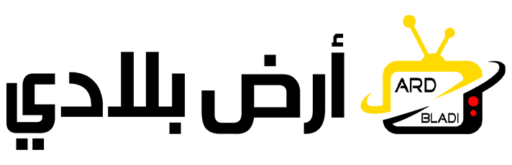جريدة أرض بلادي_الدار البيضاء_
مصطفى لغتيري

هو ذلك الرجل الهادئ المسالم، الذي لا يمكن إلا أن تحبه من أول لقاء يجمعك به، رجل يقول رأيه بكثير من الهدوء والتحفظ، ويتجنب الصدام بشكل كبير. جمعت بيننا لقاءات عدة تعز عن الحصر. بدأت في نهاية تسعينات القرن الماضي، حين تحلقنا ونحن في بداياتنا الطموحة حول نادي القصة القصيرة بالرباط برئاسة الصديق هشام حراك، الذي جمعنا وإياه الشغف بالحرف والحب الجارف لجنس القصة القصيرة، الذي حاول خدمته بما يستطيع، وذلك من خلال جميع لفيف القصاصين الشباب حوله. والحقيقة اننا تعرفنا على بعض قبل ذلك من خلال الصفحات الثقافية في الجرائد، قبل أن يجمع بيننا الواقع، فكان التعارف -نتحية لذلك- سلسا وبلا تعقيدات.
في إحدى هذه اللقاءات أهداني مجموعته البكر”الأبواب الموصدة”، التي أصدرها مشتركة مع صديقه اسماعيل بنهنية، قرأت المجموعة وكتبت عنها مقالا نقديا، اظنه أول مقال كتب عنه، وعن مجموعته تلك، ثم تتابعت اللقاءات فيما بعد، شهدت عليها اجتماعات ونواد في العديد من المدن، منها الدار البيضاء حين كنت رئيسا للصالون الأدبي، فنظمنا لقاءات عدة منها مهرجان القصة القصيرة جدا بشراكة مع جمعية درب غلف، التي كان يحتضنها اللاعب الدولي صلاح الدين بصير، كما جمعتنا مؤتمرات اتحاد كتاب المغرب فيما بعد، وفي كل لقاء كنت أجد نفسي قريبا جدا، بل متجاورا مع الصديق العزيز ابراهيم الحجري لا نكاد نفترق. نتشاور في كثير من الأمور قبل الإدلاء بالرأي، كان غالبا ما يسر لي بأرائه، بينما يركن إلى صمته المعتاد، الذي يفضله عن المشاحنات، بينما كنت أنا أحب ان أدلي برأيي أمام الجميع، لكن حين يشد النزال، دوما كنت أجد في سي ابراهيم مساندا قويا، يدعم أرائي، التي غالبا ما كانت تعبر عن أراء الكثير من الأدباء، الذين يسعون إلى تغيير بعض الأمور والسلوكات في المشهد الثقافي المغربي.
في كثير من الملتقيات كنا نرافق بعضنا حتى في السفر، أتذكر سفرنا نحو الصويرة ذات لقاء قصصي، حين قدت سيارتي نحو “حد ولاد فرج”، وهناك أخذته معي وسرنا في طريقنا نحو موغادور، وكانت لنا حكايات لا تنسى. خاصة فيما يتعلق بتناقضاتنا الجميلة، فبينما كان الحجري شخصا يركن إلى الهدوء وأداء الصلاة في اوقاتها، كنت انا أفضل أن أقيم الليل بطريقتي الخاصة، فكان الحجري يتلصص على أجوائي لبعض الوقت، ثم سرعان ما يعتذر بابتسامته الجميلة المتسامحة، ليعود ألى غرفته ويركن ألى هدوئه وكتبه، ثم إلى النوم بعد تأخر الوقت.
أتذكر كذلك لقاءنا في مدينة أكادير في ضيافة ملتقى الرواية، الذي نظمه الكاتب عبد العزيز الراشدي، وشاركنا في تلك اللحظات كثير من الأديبات والأدباء العرب، لكن ذكرى الليبي محمد الأصفر ظلت طاغية على ما سواها، لأنه خلق معنا انسجاما، جعله يبدو رفيقا قديما لنا، وربما لهذا السبب ظلت صداقتنا قائمة إلى اليوم، وكان محمد الاصفر لا يفوت يوما دون أن يسأل عن حال أخينا ابراهيم وهو في غيبوبته المقيتة بعد المرض الذي ألم به بشكل مفاجئ.
جمعتنا بعد ذلك مناسبات عدة، خاصة خلال فترة معينة كنا ننشر كتبنا معا في نفس الدار، دار النايا للسوري صافي علاء الدين، التي خلقت زخما ابداعيا مغربيا قويا، وقد ساهمت علاقتنا بالناشر آنذاك في مغربة هذه الدار ، التي كنا نحتفي بإصداراتها في معرض الكتاب بالدار البيضاء، وقد كان الحجري دائم الحضور بشكل فعال، فكانت لنا أيام لا تنسى، ونحن نخلق الحدث صحبة الناشر، الذي كان يحقق بسبب تكاتف مجهودات الكتاب المغاربة أعلى رقم مبيعات في المعرض.
كان الحجري متابعا جيدا لكل ما يصدر من كتب، اذ قلما يوجد كاتب لم يحبر الحجري بعض السطور عن كتاب له، مغربيا كان أو عربيا، وقد نالت إصداراتي كذلك كثيرا من الحظوة من طرفه، فكتب في المجلات والمواقع التي كان مراسلا لها عن بعض كتبي، وأخص بالذكر “أسلاك شائكة” و”تراتيل امازيغية” على التوالي في كل من موقع الجزيرة نت والعربية نت. هذا فضلا على الإشارة إلى بعض ابداعاتي في كتبه، التي استحقت جوائز أدبية عربية مرموقة، أهلته لتمثيل بلده المغرب خير تمثيل في المحافل الثقافية العربية الدولية.
خلال سفرنا الأخير الى تونس الذي كان باقتراح منه، بعد أن استفسره الروائي التونسي كمال الرياحي رئيس بيت الرواية السابق، الذي اختار مؤخرا الهجرة الى كندا، عن الكتاب الذي كتبوا روايات عن الأفارقة، فحدثه عن روايتي “ليلة افريقية”، لأن الملتقى الثاني الذي كان بيت الرواية يعتزم تنظيمه يتعلق بالكتابة العربية عن ذوي البشرة السوداء، فكان ان شاركنا في هذا الملتقى، ابراهيم كناقد وأنا كروائي، وبالفعل كانت رفقة طيبة وأخوية لم ينغص صفوها أي كدر، ذهبنا معا وتجولنا في تونس معا، وتعرفنا على أدباء معا، كانوا في الغالب لهم علاقة سابقة مع ابراهيم بحكم متابعته النقدية لما ينشر عربيا، فتصافت نفوسنا مع الروائي المصري السوداني الصادق الطيب واليمني علي المقري والجزائري الصديق الحاج أحمد، الذي عرفنا بأهله الجنوبيين المقمين في تونس، فكانت بحق أجمل هدية ظفرنا بها، نظرا لحبهم الكبير للمغرب والمغاربة فمحضونا بعناية خاصة، أثرت في نفوسنا بشكل كبير.
بعد عودتنا من تونس وجدنا ابني مروان في انتظارنا فنقلنا إلى وجهتنا، فكانت مناسبة سانحة ليتعرف على صديقي ابراهيم، الذي ظل يسأل عنه كلما تحدثنا أو التقينا.
آخر عمل ثقافي جمعنا معا، مشاركة أخي ابراهيم الحجري في لجنة تحكيم جائزة غاليري الأدبية دورة العربي بنجلون، وقد شرفنا سي ابراهيم بكتابة تقرير عن الكتاب الفائزة بفرع القصة القصيرة في الجائزة التي عادت للكاتبة العراقية رسمية محيبيس فيما كتب تقرير الكتاب الفائز بالشعر وهو للشاعرة اليمنية انتصار حسن الكاتب عبد الدين حمروش، بينما كتب تقرير الكتاب الفائز بفرع القصة القصيرة وهو للكاتب الحسين الناصري الناقد سعيد بوعيطة. وقد كانت مشاركة سي ابراهيم كالعادة في هذه اللجنة فعالة وتعبر عن خبرة قوية في المجال الأدبي.
آخر لقاء به كان في مستشفى خليفة بالدار البيضاء. زيارة أولى تمتعت بنوع من الأمل، كانت خلالها حالة صديقنا تبدو في بداياتها ويمكن التعامل معها وإنقاذه منها، الزيارة الأخيرة كانت مخيبة للآمال، محبطة بشكل لا يمكن تصوره، لحظتها لم استطيع المكوث هناك كثيرا. هرولت هاربا من المستشفى والحسرة تعتصر قبلي، بعد مغادرتي قررت ان لا أعود ابدا ألى المستشفى إلا اذا حدثت معجزة، أعادت لنا سي ابراهيم معافى الى حضننا، فلن أتحمل رؤيته على الحال التي رأيته عليها. وخاصة مشهد امه /امي، تلك المسكينة العاجزة أمام مأساة ابنها، التي تتناسل فصولها أمام عينيها الحزينتين.
بعدها مباشرة قررت السفر، كي أبتعد عن هذه الأجواء المحبطة ما دمت عاجزا عن فعل أي شيء، قضيت أياما في مراكش ونواحيها محاولا تناسي الأمر، ودافنا هواجسي في جب الذات العميق، وكأنني بذلك أحاول استبعاد ما يمكن أن يحدث في أي وقت، متمسكا برحاء واه في شفائه.
بعد عودتي من السفر جاءني الخبر اليقين، وتهاوى الأمل، وتشظى إلى شظايا متناثرة يصعب لملمتها، وبذلك حدثت الكارثة، وفقدت أخا لم تلده لي أمي بحق.